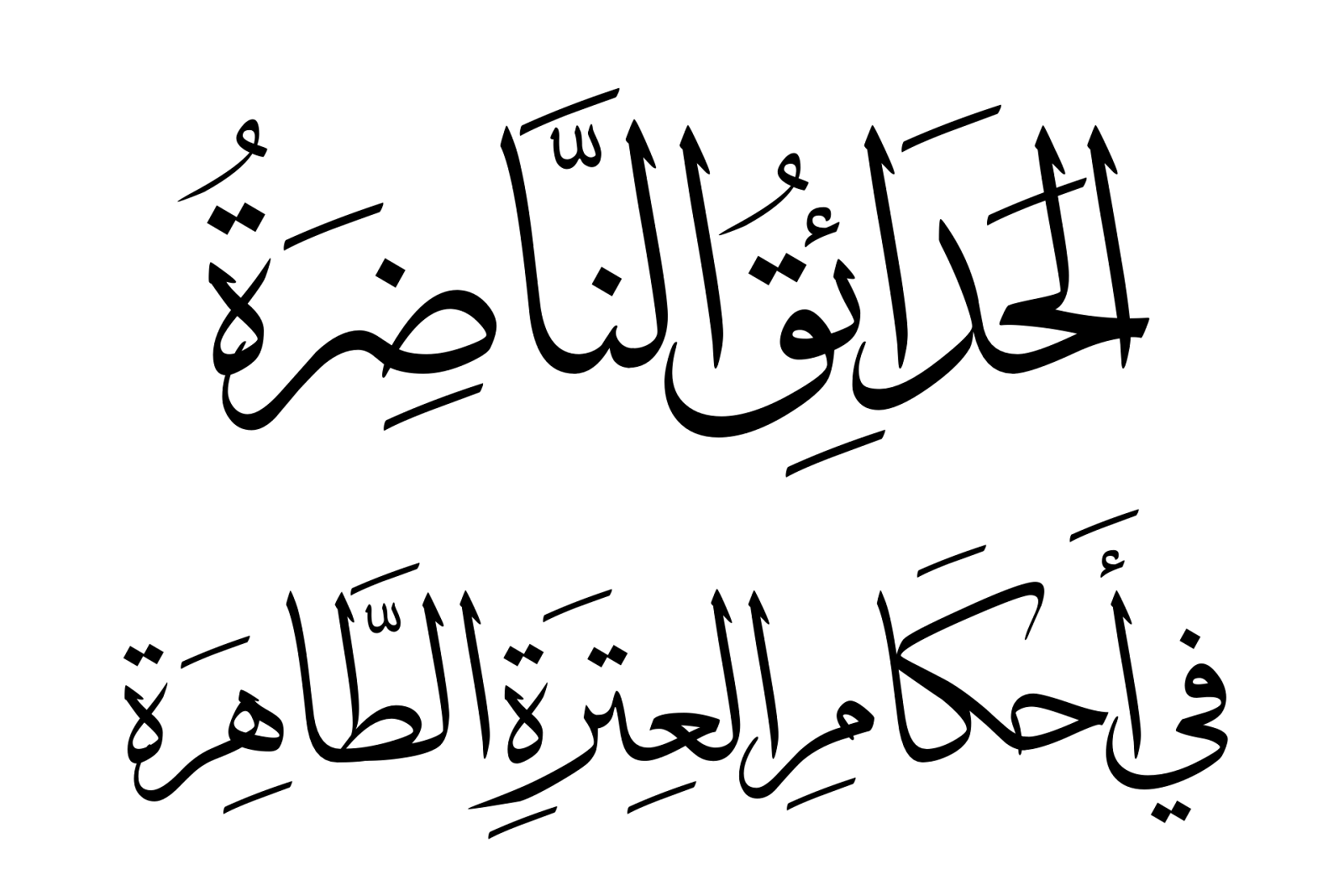الرسالة الصلاتية - اللواحق
الباب الثالث
وفيه مقاصد:
المقصد الأول
في القضاء
يجب قضاء الصلاة اليومية على كل مكلف فاتته عمداً كان أو سهواً، وعلى أي حال كان، ما لم يكن الفوات لصغر أو جنون أو كفر أصلي أو حيض أو نفاس إجماعا في الجميع نصاً وفتوى، وإغماء على الأشهر الأظهر وقيل بوجوب القضاء عليه مطلقاً، وقيل أنه يقضي آخر أيام إفاقته إن أفاق نهاراً أو آخر ليلته إن أفاق ليلاً، والأخبار في هذه المسألة على غاية من الاختلاف مع كثرتها وصحة أكثرها فبعض صرح بقضاء جميع ما فاته حال الإغماء، وبعض صرّح بقضاء ثلاثة أيام، وبعض صلاة يوم واحد، والأظهر حملها على الاستحباب جمعاً بينها وبين ما دل على السقوط.
وفي أكل ما يزيل العقل جهلاً أو لضرورة أو يؤدي إلى الإغماء إشكال ، وظاهر المشهور أنه غير موجب القضاء لعذر الجهل أو لضرورة ودليله من الأخبار غير واضح بل ظاهر إطلاق أخبار القضاء وعمومها يشمله.
واستند بعضهم في المغمى عليه، وفيه أن جملة من تلك الأخبار قد صرحت بأن الإغماء إعادة المرض ويؤيده ما علل به في جملة أخرى منها أيضاً بأن ما غلب عليه الله أولى بالعذر وهو ظاهر في كون الإغماء من جهة الله تعالى لا من قبل المكلف.
ومن هذا التعليل ربما يفهم أيضاً وجوب القضاء على الحائض والنفساء إذا كان ذلك عن شرب الدواء لذلك، وإن كان ظاهرهم الاتفاق على خلافه عملاً بإطلاق أخبار الحيض والنفاس مع أن جملة من محققيهم صرحوا بأن الأحكام المودعة في الأخبار إنما تحمل على الأفراد الشايعة المتكررة المتبادرة عند الإطلاق دون الفروض النادرة الوقوع وبموجب ذلك يجب حمل إطلاق تلك الأخبار على غير هذه الصورة المفروضة مما هو المتعارف من صدور الحيض والنفاس من قبل الله تعالى كما هو العادة الجارية، وبالجملة فالأحوط عندي وجوب القضاء في المسألة المذكورة.
والمشهور بين الأصحاب بل الظاهر أنه لا خلاف فيه أن فاقد الطهورين لا يجب عليه الأداء لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة ولا صلاة إلا بطهور كما في الصحيح، وأما القضاء فقد اختلفوا فيه على قولين أحدهما السقوط أيضاً، والآخر القول بوجوب القضاء وهو الأقرب إلا أن الأحوط حيث أن المسألة عارية من النص عليها بالخصوص هو الصلاة أداء ثم القضاء بعد زوال العذر.
ثم انه قد اختلف الأصحاب (رضي الله عنهم) في وجوب تقديم الصلاة الفائتة على الحاضرة وعدمه على أقوال:
أحدها: وهو المشهور بين المتقدمين هو القول بالمضايقة المحضة وهو وجوب صلاة الفائتة ساعة ذكرها متحدة كانت أو متعددة ما لم يتضيّق وقت الحاضرة، فلا يجوز له صلاة الحاضرة إلا عند ضيق الوقت لو كان عليه فوائت متعددة.
وقيل وهو من المتقدمين أيضاً بالمواسعة بل استحبابه، والمشهور بين المتأخرين هو هذا القول لكنهم صرحوا باستحباب الفائتة.
وقيل بوجوب تقديم الفائتة المتحدة واستحباب المتعددة، وقيل بوجوب تقديم الفائتة إذا ذكرها في يوم الفوات إتحدت أو تعددت.
والأظهر عندي من هذه الأقوال هو القول الأول وهو الذي عليه المعوّل لدلالة الآية والروايات الصحيحة عليه، وقبول ما دل على المواسعة للتأويل مع ضعفه عن المعارضة، وأما القولان الأخيران فلا وجه لهما يعتمد عليه.
ولو فاتته فريضة واحدة من الفرائض اليومية وكانت مشتبهة بما يوافقها عدداً قضى العدد مردداً في النية بين الفرائض المحتملات إن ظهراً فظهر وإن عصراً فعصر وإنا عشاءً فعشاء مخيراً في الجهر والإخفات.
ولو اشتبهت بما يخالفها في العدد كأن يشك بين كون الفايتة ظهراً أو مغرباً أو صبحاً وجب عليه الإتيان بالفرائض الثلاث.
ولو شك في فريضة من الفرائض الخمس فإنه يأتي بأربع مرددة بين الرباعيات الثلاث وثلاثية ينوي بها المغرب وثنائية ينوي بها الصبح، وقيل هنا بوجوب الفرائض الخمس، والأول الأظهر.
ويقضي فائتة السفر قصراً وإن كان في السفر، ويقضي الصحيح فايتة المرض على الكيفية التي عليها المريض، ولا يؤخرها إلى حال الصحة.
ويستحب قضاء الراتبة اليومية استحباباً مؤكداً لا سيما فايتة الصحة حتى ورد من ترك القضاء تشاغلاً بالدنيا لقي الله وهو مستخف متهاون مضيع لحرمة رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم، وأنه مع تعذر القضاء عليه يتصدق عن كل ركعتين بمد.
ويقضي ولي الميت وهو أولى الناس بميراثه ما فاته مطلقاً أي لعذر كان أو لا لعذر في مرض الموت أم لا عملاً بالطلاق وللأصحاب أيضاً هنا اختلاف في القاضي والمقضي والمقضي عنه والأظهر ما ذكرناه.
المقصد الثاني
في صلاة الجماعة
وهي مستحبة في الصلاة اليومية استحباباً مؤكداً، وقد ورد في الحث عليها حتى استفاضت الأخبار باستحقاق حرق بيت تاركها عليه مع تهاونه بها، وسقوط عدالته، ووجوب هجرانه، وجواز غيبته، مضافاً إلى ما ورد فيها من الثواب العظيم والأجر الجسيم.
وهي واجبة في الجمعة والعيدين مع وجود الشرائط المعتبرة هناك، والأشهر تحريمها في النافلة إلا في الاستسقاء والعيدين مع اختلال الشروط، وكذا الغدير على قول، وإعادة المنفرد جماعة.
وأقلها اثنان أحدهما إمام والآخر مأموم.
ويشترط في الإمام شروط:
منها الذكورة إذا أم ذكوراً اتفاقاً نصاً وفتوى.
ومنها البلوغ احتياطاً، والمشهور اشتراط البلوغ، وقيل يجوز إمامة الصبي المميز المراهق، وروايات الجواز أرجح من روايات المنع، فلذا جعلنا شرط البلوغ احتياطاً ، وقيل بجواز إمامته بمثله وقيل مطلقاً، لكن في النافلة ولم نقف لهما على دليل.
ومنها أن يكون مؤمناً عدلاً عاقلاً إجماعاً هنا نصاً وفتوى.
وقد اختلف أصحابنا (رضي الله عنهم) في معنى العدالة هنا على أقوال أظهرها عندي وفاقاً لجمع متأخري المتأخرين أنها عبارة عن حسن الظاهر حسبما دلت عليه صحيحة عبدالله ابن أبي يعفور.
والمراد بحسن الظاهر أن يكون الإنسان معروفاً بالقيام بالواجبات العلمية والعملية والقلبية والقالبية مجتنباً للمحرمات كذلك غير مصر على شيء من الصغائر فضلاً عن الكبائر، ملازماً للجماعة والصلاة في أوقاتها فمتى كان معروفاً بذلك معلوماً سلوكه تلك المسالك ثبتت عدالته وأجيزت شهادته، وصحّت جماعته.
ولا بد من نوع معاشرة وصحبة تطلع على ذلك.
ومنها أن يكون طاهر المولد بلا خلاف أيضاً نصاً وفتوى.
وفي اشتراط حريته وسلامته من البرص والجذام والعمى قولان أظهرهما العدم في الأول والأخير والاشتراط في الوسط فيجوز الصلاة خلف العبد والأعمى إذا كان له من يسدده إلى القبلة، وتحرم الصلاة خلف الأخيرين.
والمشهور جواز إمامة المرأة بمثلها بل عليه الإجماع وقيل بالمنع مطلقاً في الفرائض، والجواز في النوافل، ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار، والمسألة لا تخلو من إشكال والأحوط المنع مطلقاً.
ويشترط في صحتها عدم الحائل بين الإمام والمأموم، وكذا بين المأمومين بعضهم مع بعض على وجه يمنع المشاهدة، ولا بأس بالحائل في ائتمام النساء بالرجل.
ويشترط أيضاً عدم علو الإمام بما يعتد به فلا يضر العلو يسيراً وقيل بالكراهة إلا إذا كانت الأرض مبسوطة فيجوز أن يقف الإمام في المكان المرتفع منها، والمراد بالأرض المبسوطة أن يكون ارتفاعها منبسطاً لا نتوأ ظاهراً أما بالعكس وهو وقوف الإمام في مكان أخفض من مكان المأموم فلا بأس وإن كان الأفضل المساواة.
ويشترط عدم التباعد بين الإمام والمأمومين، وكذا بين المأمومين بعضهم مع بعض بما لا يتخطّى عادة وقدر بمسقط جسد الإنسان إذا سجد.
والمشهور عندهم الرجوع في البعد المنهي عنه إلى العرف، وهو بعيد وقيل انه عبارة عمّا يمنع المشاهدة والاقتداء بأفعال الإمام وهو أبعد، وقيل يجوز البعد بثلاثمائة ذراع وهو أبعد وأبعد والأصح ما ذكرناه أولاً وفاقاً لجملة من متأخري المتأخرين، ومن هنا صرح بعضهم بأن الأحوط للبعيد من المأمومين أن لا يحرم حتى يحرم من هو أقرب ممن يزول التباعد المذكور وهو كذلك.
ويشترط أيضاً عدم تقدم المأموم على الإمام وهذا الحكم وإن لم نقف فيه على نص إلا أنه المستفاد من أخبار الجماعة لأنها قد صرحت بالمساواة إن كان المأموم واحداً، والمتأخر عن الإمام إن كان أكثر فجواز التقديم لا دليل عليه، والعبادة توقيفية، يقتصر فيها على الكيفية الواردة في الشرع مضافاً ذلك إلى إجماع الأصحاب على الحكم المذكور.
والمشهور بين الأصحاب استحباب وقوف المأموم الواحد، إذا لم يكن امرأة عن يمين الإمام محاذياً له وتأخر الأزيد من واحد، وقيل بوجوب ذلك ، وظواهر الأخبار تعضد هذا القول، والاحتياط يقتضي المحافظة عليه، وأما المرأة فإنه يجب تأخرها وإن كانت واحدة.
ويشترط أيضاً المتابعة في الأفعال دون الأقوال على الأشهر الأظهر، وقيل بالوجوب في الأقوال أيضاً، والأحوط ذلك إلا تكبيرة الإحرام فإنه يجب المتابعة فيها إجماعاً فلو تقدم فيها على الإمام بطلت صلاته، ولو تقدم المأموم على الإمام في الركوع والسجود أو في الرفع منهما فالمشهور، إنه إن كان تقدمه عامداً فإنه يجب عليه البقاء على حاله حتى يلقه الإمام وإن كان تقدمه ساهياً أو ظاناً وجب عليه الرجوع إلى الإمام، وزيادة الركن هنا مغتفرة بالنص الدال على الرجوع مطلقاً، وفي المسألة تفاصيل لا تليق بهذا الإملاء، وقد استوفيناها في شرح الرسالة الصلاتية من أرادها فليرجع إليها.
ويشترط أيضاً اتحاد النوع بأن يكون صلاة الإمام وصلاة المأموم من نوع واحد فلو اختلف كالصلاة اليومية مع صلاة الآيات أو العيدين أو بالعكس لم يجز الاقتداء.
ولا يشترط اتحاد الصنف كالمتنفل بالمفترض وبالعكس والمقصر بالمقيم وبالعكس فإنه لا مانع من الاقتداء هنا، كما دلت عليه الأخبار ولا يشترط الاتحاد في عدد الركعات كالصبح بالظهر، وبالعكس وخلاف ابن بابويه هنا حيث نقل عنه اشتراط الكمية شاذ تدفعه الأخبار، فلا يلتفت إليه.
وقد اشتهر الخلاف في حكم قراءة المأموم خلف الإمام جوازاً أو تحريماً في الجهرية والإخفاتية وتعددت الأقوال في المسألة حتى أنه قيل لم يبلغ خلاف في مسألة من مسائل الفقه إلى ما بلغ إليه الخلاف في هذه المسألة، والذي تحقق عندي من الأدلة هو تحريم القراءة على المأموم في أوليي الإمام في صلاة جهرية كانت أو إخفاتية إلا في الجهرية التي لا يسمع فيها صوت الإمام ولو همهمته فإنه يتخير في القراءة وعدمها ورن كان الأفضل القراءة وفي أوليي المسبوق إذا اتفقتا أو أحدهما مع أخيرتي الإمام فإن الأظهر عندي وجوب القراءة على المأموم.
ولا خلاف في إدراك الركعة مع الإمام قبل تكبيرة الركوع، والمشهور أنه تدرك معه بعد الركوع أيضاً، وقيل أنه تفوت المتابعة، ولا يجوز الدخول حينئذٍ، والأول أظهر.
وأما بعد الرفع من الركوع، وكذا حال التشهد فالمشهور استحباب الدخول معه، والمتابعة فيما يأتي به من الأفعال ثم بعد قيام الإمام لما بقي من صلاته إن بقي شيء أو بعد تسليمه إن كانت تلك الركعة آخر صلاته فإنه يجب على المأموم إعادة النية وتكبيرة الإحرام للزوم زيادة الركن أو الواجب عمداً في الصلاة لو اعتد بما أتى به وقيل أنه يكفي بتلك النية الأولى والإحرام الأول والزيادة مغتفرة بالنص والأحوط عندي أنه لا يدخل في هذا الحال مع الإمام لأن أدلة المسألة لا تخلو من اضطراب.
والمشهور أن القدوة لا تفوت بفوات المتابعة في ركن بمعنى أنه لو تأخر المأموم عن الإمام في ركوع أو سجود ولم يلحقه إلا بعد فوات الركن فإنه لا تبطل قدوته لو كان متعمداً بل ولو كان في ركعتين أيضاً بل يركع أو يسجد ويلحق به في باقي صلاته، والأظهر عندي البطلان في الصورة المذكورة إلا إن كان تأخيره لعذر من سهو أو زحام يمنعه الركوع والسجود.
والأشهر الأظهر أن العالم بفسق الإمام أو حدثه أو كفره أو نحو ذلك من الأمور الموجبة البطلان القدوة بعد تمام الصلاة معه لا يعيد بل صلاته صحيحة، وقيل بوجوب الإعادة وهو ضعيف ترده صحاح الأخبار.
ولو علم بذلك في أثناء الصلاة عدل إلى نية الانفراد وأتم صلاته منفرداً.
تذنيب: في نبذ من مستحبات صلاة الجماعة:
منها أنه لو تشاح الأئمة في التقدم للأمام فإنه يستحب تقديم من اختاره المأمومون.
ولو اختلفوا وأراد كل قوم تقديم إمام فليس لهم ذلك بل يرجع إلى مراتب الترجيح بين أولئك فصاحب المنزل في منزله، وصاحب السلطان أي الإمارة من قبل إمام الحق أحق بالتقديم في منزله وسلطانه إجماعاً نصاً وفتوى فيما أعلم، والمشهور أيضاً أن صاحب الراتبة في مسجد أحق بذلك ودليله لا يخلو من مناقشة وإن كان الأحوط ذلك.
ثم إنه يقدم الأعلم الأفقه على الأظهر وفاقاً لجملة من محققي متأخري المتأخرين وإن كان خلاف ما هو المشهور فإنهم قدموا هنا الأقرأ على الأعلم والأدلة العقلية والنقلية تدفعه.
ثم مع التساوي في هذه المرتبة يقدم الأقرأ، وفي تفسير المغنى المراد به إجمال فهل المراد به الأجود اتقاناً للحروف وأشد إخراجاً لها من مخارجها كما ذكره بعض أو بإضافة الأعرفية بالأصول والقواعد المقررة بين القراء كما قيل أيضاً أو الأكثر قرآناً وقراءة كما يشير إليه بعض الأخبار أو الأجود بحسب طلاقة اللسان وحسن الصوت وجودة المنطق واللحن احتمالات.
ثم مع التساوي في ذلك فالأكبر سناً قالوا بمعنى علو سنه في الإسلام، وقد ذكر الأصحاب في هذه المراتب أيضاً الأقدم هجرة والظاهر أنه لا تحقق له في غير وقته صلى الله عليه وآله، والخبر بهذه المراتب منقول عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فالظاهر قصر هذه المرتبة على زمانه وما قرب منه، وأما ما تكلفه أصحابنا في تفسير معنى الهجرة باعتبار الترجيح بهذه المرتبة في الأزمان المتأخرة، فالظاهر بعده وعدم استقامته.
ومنها أنه يستحب إقامة الصفوف أي جعلها معتدلة لا اعوجاج فيها.
ومنها اختصاص ذوي المزية وأهل الفضل بأول الصفوف لأجل أنه إن نسي الإمام أو تعايا قوموه، وإن أصابه حادث قدّم بعضهم.
ومنها سد الخلل والفروج في الصفوف ليكون الصف متصلاً مملوءاً.
ومنها أن الأفضل للإمام أن يصلي صلاة أضعف من خلفه.
ومنها أن الأفضل له أن يقوم حتى يتم المسبوق خلفه.
ومنها أن يسمع من خلفه جميع الأذكار ويتأكد في التشهد وأن الأفضل للمأموم أن لا يسمع الإمام شيئاً من أذكاره.
ومنها القيام للصلاة عند قول المقيم قد قامت الصلاة .
ومنها عدم التفل حال الإقامة بمعنى أنه لا يشرع في النافلة في ذلك الوقت، وأما لو كان في نافلة ثم أقيمت الصلاة فإنه يتمّها بغير كراهة.
ومنها أن يقطع النافلة لو خاف عدم إدراك الركعة.
ومنها نقل الفريضة إلى النافلة لأجل إدراك الركعة أيضاً.
ومنها التسبيح حال قراءة الإمام في الصلاة الإخفاتية، وكذا وردت الرخصة به في الجهرية أيضاً، لكن ينبغي أن يكون خفياً لا يمنع الإنصات.
ومنها تنبيه الإمام إذا أخطأ وتقويمه إذا تعايا.
ومنها أن يعيد من صلى منفرداً صلاة جماعة مع قوم مبتدئين بالصلاة إماماً كان أو مأموماً وفي إعادة الجماعة الذين قد صلّى كل واحد منهم منفرداً جماعة بحيث يأتم بعضهم ببعض إشكال ينشأ من أن مورد الأخبار وإنما هو من صلى منفرداً ثم وجد جماعة مبتدئين الصلاة فإنه يستحب له الصلاة جماعة بأن يؤمهم، ويصلي بهم أو يأتم بإمامهم فالمعادة إنما هي إحدى الصلاتين لا الجميع.
وأشكل منه إعادة الجامع أي من صلى جماعة ثم وجد جماعة أخرى فيصلي معهم جماعة استحباباً، وقد قيل بالاستحباب في الموضعين وهو مشكل لما عرفت من الخروج عن موضع النصوص، ولاسيما الثاني إذ العبادات توقيفية يجب الوقوف فيها وجوباً واستحباباً على ما رسمه صاحب الشريعة.
المقصد الثالث
في صلاة السفر
تسقط أخيرتا الصلاة الرباعية في السفر، اتفاقاً نصاً وفتوى، وكذا تسقط نافلتها بشروط:
أحدها: قصد ثمانية فراسخ متصلة أو ملفقة من الذهاب والإياب.
والفرسخ ثلاثة أميال بلا خلاف، والميل أربعة آلاف ذراع، فلو قصد أقل من ذلك ثم بعد بلوغ مقصده قصد أقل أيضاً وهكذا: كطالب الآبق والحاجة حتى يرجع متى وجد ذلك فإنه يجب عليه التمام، وإن قطع مسافات بهذه الكيفية، نعم متى أراد الرجوع فإن كان قدر ذلك المسافة ثمانية فراسخ وجب لتقصير لتحقق المسافة المذكورة.
وفي قصد الأربعة خاصة خلاف والمشهور أنه إن أراد الرجوع ليومه أو ليلته وجب عليه التقصير وإلا فالتمام، وقيل بوجوب التقصير إن قصد الرجوع كما في الأول، ولو لم يقصد الرجوع ليومه أو ليلته فهو بالخيار إن شاء أتم وإن شاء قصر، وقيل بهذا القول أيضاً إلا أنه خص التخيّر بالصلاة ومنع من التقصير في الصوم، وبالتخيير لقصد الرجوع ليومه، وقيل بالتخيير مطلقاً قصد الرجوع ليومه أو لم يقصد، وقيل إنه إن قصد الرجوع في ضمن العشرة وجب التقصير وإلا فلا.
فهذه ستة أقوال في المسألة وهذا الاختلاف ناشئ عن اختلاف الأنظار في الجمع بين الأخبار الواردة في هذا المضمار، والأظهر عندي منها هو القول الأخير وفاقاً لبعض المتقدمين وجملة من محققي متأخري المتأخرين.
وثانيها: استمرار القصد، أي البقاء على قصده وعدم العدول عنه إلى أن تحصل المسافة التي هي الثمانية والأربعة مع إرادة الرجوع وحينئذ فلو رجع عن القصد الأول قبل بلوغ ذلك انقطع سفره ووجب عليه التمام، وكذا لو بقي متردداً بين السفر وعدمه كمنتظر الرفقة إن جاؤوا سافر وإلا فلا يجب عليه الإتمام سواء بقي في محله أو رجع إلى وطنه.
وهل يقضي للصلاة التي صلاها بعد السفر، وقيل الرجوع أو التردد أم لا، المشهور العدم وهو الأوفق بمقتضى الأصول الشرعية لأنها صلاة شرعية مأمور بها في ذلك الوقت وللرواية الصحيحة الدالة على ذلك وقيل بوجوب القضاء واستدل عليه ببعض الأخبار الضعيفة السند وحملها الأصحاب على الاستحباب جمعاً إلا أن في المسألة رواية صحيحة صريحة دالة على وجوب القضاء لم يذكرها أحد من الأصحاب أوجبت الإشكال في هذا الباب فالاحتياط عندي واجب بالقضاء لذلك.
وثالثها: أن لا ينقطع سفره بأحد القواطع الثلاثة المشهورة وهي إقامة العشرة الأيام فما زاد أو وصول منزل قد استوطنه ستة أشهر وقيل باستيطانه كل سنة ستة أشهر والأول أظهر وفي غيره من العقارات تردد أحوطه الجمع بين القصر والإتمام أو مضي ثلاثين يوماً متردداً في الخروج وعدمه بقوله غداً أخرج أو بعد غد وهكذا حتى تمضي المدة المذكورة.
ورابعها: أن لا يكون السفر عمله، والمشهور عبائر الأصحاب التعبير عن ذلك بكثير السفر وهو من يزيد سفره على حضره، وفي الجمع بين كلامهم في هذه المسألة وبين أخبار المسألة غاية الإشكال، فلو كان السفر عمله كالملاح والمكاري والراعي ونحوهم وجب عليه بعد مضي العشرة إذا أراد إنشاء السفر التقصير ، والمشهور بين الأصحاب عموم هذا الحكم لغير المكاري من كثير السفر والموجود في الرواية التي هي مستند هذا الحكم المكاري خاصة ثم إنهم قد ذكروا أنه يرجع إلى التمام بعد السفرة الثالثة وقيل بعد الثانية والنص مجمل، والمسألة لا تخلو من شوب الإشكال كما أوضحناه في شرح الرسالة الصلاتية.
وخامسها: كون السفر سائغاً وجائزاً شرعاً بمعنى أن لا يكون معصية فلو كان كذلك فإنه لا يقصر صاحبه، بل يجب عليه التمام اتفاقاً نصاً وفتوى، ولو كان أصل قصد السفر معصية ثم في أثناء السفر عدل عن تلك النية إلي نية الطاعة فإنه يجب عليه التقصير حينئذ أن كان الباقي مسافة لأنه سفر شرعي.
ولو كان السفر طاعة ثم عدل في أثنائه إلى قصد المعصية بذلك السفر زال الحكم الأول ووجب عليه التمام لعدم المشروعية، ولو عدل بعد ذلك عن المعصية إلى الطاعة رجع إلى حكمه الأول، وهل يشترط هنا كون الباقي مسافة أيضاً قيل نعم لبطلان المسافة الأولى بقصد المعصية بعدها، وقيل لا وهو الأظهر وعليه الأكثر لأن المانع من التقصير إنما هو المعصية وقد زالت، وللرواية أيضاً.
وسادسها: بلوغ محل الترخّص فقيل بلوغه يكون في حكم أهل البلد، والمراد من محل الترخص هو الموضع الذي لا يسمع فيه أذان البلد الذي خرج منه أو لا يرى أهل البيوت يعني من كان في آخر خطة البلد من الأشخاص بحيث يتوارون عن نظره فلا يراهم فإذا كان كذلك وجب عليه الصلاة قصراً.
وفي عبارات الأصحاب هنا ما يوجب الإشكال، والاختلاف التام بين العلامتين المذكورتين حيث أنهم اعتبروا تواري البيوت نفسها عن المسافر وخفائها عن نظره وهو في غاية البعد عن خفاء الأذان وذلك لأنه لا يحصل إلا بقطع مسافة كثيرة تزيد على خفاء الأذان، وأما ما ذكرناه وهو المفهوم من النص الوارد في المسألة فهو قريب من خفاء الأذان.
وكيف كان فما ذكرناه في هذه المسألة من هذا الشرط هو المشهور، وقيل أنه يقصّر بمجرد خروجه من منزله.
هذه جملة الشرائط في وجوب التقصير على المسافر.
ولو جهل المسافر وجوب التقصير عليه فصلى تماماً صحت صلاته لموضع الجهل على الأشهر الأظهر، وقيل بوجوب الإعادة عليه في الوقت وهو ضعيف.
ولو صلى كذلك ناسياً فالأظهر الأشهر الإعادة في الوقت دون خارجه، وقيل بالإعادة مطلقاً.
ولو جهل من وجب عليه التمام وجوب التمام عليه فصلى قصراً كمن دخل بلداً ونوى الإقامة بها، ولم يعلم أن نية الإقامة موجبة لوجوب التمام عليه فصلى قصراً فالأظهر صحة صلاته أيضاً، وقيل بالعدم لعدم حصول الامتثال المقتضي للإجزاء وهو ضعيف، والنص الصحيح حجة عليهم.
وألحق بعضهم بالجاهل هنا ناسي الإقامة، فحكم بأنه لا إعادة عليه ولم أقف له على دليل ، إذا مورد النص الجاهل خاصة.
ومن دخل من سفره فإنه لا يجب عليه الإتمام حتى يجاوز محل الترخص بحيث يسمع الأذان أو يرى أهل البيوت على المشهور، وقيل أنه لا يتم إلا إذا دخل منزله وأكثر الأخبار تدل على هذا القول، وما تأولها به الأصحاب بعيد فالقول به هو الأظهر، والقول بالتخيير جمعاً بين الدليلين غير بعيد.
والأشهر الأظهر أن من كان في أحد الأماكن الأربعة المشهورة، فإنه يتخير بين القصر والإتمام، والإتمام أفضل وقيل بوجوب القصر كغيرها من الأماكن وقيل يطرد الحكم بالمشاهد الشريفة والضرائح المقدسة فيتخير فيها أيضاً والمعتمد الأول.
ومن نوى الإقامة في بلد وعرض له الرجوع عنها إلى إرادة السفر فإن لم يصل فريضة من الفرائض المقصورة على التمام فإنه يبقى على حكم القصر، وإن صلى فريضة على التمام وجب عليه الصلاة تماماً حتى يقصد السفر على الوجه المتقدم والشروط المقررة.
ومن أقام في بلد جاز له الخروج إلى ما دون الترخص، أما لو خرج بعد العشرة أو في أثنائها إلى ما دون المسافة مما يزيد على محل الترخص، فرن عزم على العود إلى محل الإقامة بعد خروجه ونوى الإقامة ثانياً أتم في الذهاب والإياب وفي الموضع الذي ذهب إليه.
وإن لم ينو الإقامة فهناك أقوال: فقيل بأنه يقصر بمجرد خروجه معللاً ذلك بأنه يبطل حكم البلد بالمفارقة فيعود إليه حكم التقصير، وهذا التعليل ضعيف وقيل بوجوب الإتمام في الذهاب والمقصد، والتقصير في الرجوع وفي البلد حتى يسافر منها لأنه برجوعه صار قاصداً للمسافة.
وهذا القول على إطلاقه مشكل لأنه إن تم فإنما يتجه بالنسبة إلى من كان قصده بعد الرجوع إلى السفر، وإلا فلو لم يكن كذلك بأن كان ذاهلاً أو متردداً في السفر وعدمه فإنه لا يتجه ما ذكره وقيل أنه يبقى على التمام ذهاباً وإياباً وفي البلد التي يرجع إليها حتي يقصد مسافة لأنها صارت في حكم بلده.
والمسألة عارية من النص الدال على حكمها صريحاً، والاحتياط فيها مطلوب وإن أمكن الترجيح في بعض شقوقها إلا إنه لا يبلغ إلى حد يوجب الفتوى به.
ومن دخل عليه الوقت في بلده وسافر ولم يصل إلى أن تجاوز محل الترخص أو بالعكس بأن دخل عليه الوقت في السفر ثم ترك الصلاة حتى دخل البلد، فللأصحاب (رضوان الله عليهم) فيها أقوال مختلفة لاختلاف النصوص الواردة في المسألة.
فقيل باعتبار حال الأداء في الموضعين ليصلي قصراً في الصورة الأولى لأنه في وقت أداء الفريضة مسافر فيصلي صلاة السفر ويصلي تماماً في الصورة الثانية، لأنه في ذلك الوقت حاضر فيجب عليه التمام وهذا هو الأظهر عندي، وعليه العمل وقيل بالتخيير بالموضعين بين القصر والإتمام، وقيل بالتفصيل بسعة الوقت وعدمها فإن اتسع الوقت صلى تماماً وإلا صلى قصراً في الموضعين، وقيل انه يعتبر بحال الوجوب في الشق الأول، وبحال الأداء في الثاني وعلى هذا القول يتم في الحالين، وقيل بعكسه ويقصر في الحالين والأصح عندي كما عرفت هو الأول لصحة دليله وصراحته وتطرق التأويل إلى باقي أدلة هذه الأقوال لعدم الصراحة فيها.
ويستحب جبر الصلاة المقصورة بالتسبيحات الأربع وهي: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر بأن يقولها في دبر الصلاة المقصورة ثلاثين مرة.
خاتمة
اعلم أيدك الله تعالى بتأييده، وجعلك من خلّص عبيده:
إننا حيث قد أكثرنا في مطاوي أبحاث هذه الرسالة من الأمر فيها بالرجوع إلى الاحتياط فالواجب الإشارة إلى السبب في ذلك، وتحقيق معنى الاحتياط، وما يجب وما لا يجب.
فنقول وبالله الثقة: إن الأخبار الواردة عن الأئمة الأطهار (صلوات الله عليهم) لما كانت على غاية من الاختلاف في الأحكام الشرعية بسبب عموم محنة التقية كان تحصيل الحكم الشرعي منها على وجه يجوّز الحكم والفتوى في غاية الصعوبة والإشكال لما ورد في الفتوى مع عدم العلم من الخطر العظيم، والعذاب المقيم، والتهديد الشديد بالنار، وما فيها من مقامع الحديد، فالواجب على الفقيه المتدين بالورع والتقوى والمتمسك من ذلك بالسبب الأقوى، التورع حسب الإمكان عن الوقوع في مهاوي الحكم والفتوى، والوقوف على جادة الاحتياط في العلم والعمل لينجو بذلك من الزلل والخطل، وأن لا يتجشم الفتوى إلا مع وضوح الدليل، وكونه نير السبيل، ولا يغتر بمن خلع عن عنقه ربقة الخوف والتقوى، وصار يخبط في الفتوى خبط عشواء فلا ترد عليه مسألة إلا وأفتى فيها برأيه، ومال إلى هواه، فإنه من اتباع الشيطان الذي استضله واستغواه.
ثم إنه يجب أن يعلم أن الاحتياط عبارة عما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف على جميع الاحتمالات، ويصير بريء الذمة على جميع المقالات، وأنه ينقسم عندنا إلى واجب ومستحب، فالواجب منه ما كان في مقام الاشتباه في الحكم الشرعي بمعنى أنه لم يظهر ذلك الحكم من الدليل ظهوراً يوجب الإفتاء به، والقول بأنه حكم الله تعالى في المسألة، والوجه فيه أنه استفاضت الأخبار بأن الأحكام على ثلاثة أقسام: حلال بين، وحرام بين، وشبهات بين ذلك، فمن اجتنب الشبهات نجا من الوقوع في الهلكات.
ومعنى الحلال البين هو الذي حليته بينة من الدليل الشرعي، وكذا الحرام البين هو الذي تحريمه معلوم ومجزوم به من الدليل الشرعي، وما لم يكن كذلك فهو من الشبهات، والحكم في الشبهات كما استفاضت به الروايات هو الوقوف فيها عن الحكم والفتوى والأخذ في العلم بطريق الاحتياط وجوباً.
والاشتباه الموجب للاحتياط قد يكون منشأه وسببه عدم الوقوف على الدليل في الحكم، وقد يكون سببه عدم وضوح الدليل واحتماله لمعان متعدده، وقد يكون سببه التردد في اندراج بعض الجزئيات تحت كليات مختلفة الحكم ونحو ذلك، والمستحب ما لم يكن كذلك بأن يكون الحكم الشرعي قد وضع على وجه يوجب الفتوى به لكن لأجل الخروج عن مخالفة الدليل المقابل واحتمال أن يكون الحق فيه، يحتاط بالخروج عن مخالفة الدليلين معاً، هذا عند أصحابنا الإخباريين.
وأما عند المجتهدين فإن الأحكام عندهم لا تخرج عن قسمين إما حال أو حرام لعملهم على البراءة الأصلية في الأحكام الشرعية فالاحتياط عندهم بجميع أقسامه مستحب.
وكيف كان فلا ريب في رجحان الاحتياط واستحبابه كما استفاضت به الأخبار مثل قول أمير المؤمنين عليه السّلام لكميل بن زياد: يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك.
وقول الصادق عليه السّلام: وخذ بالاحتياط لدينك في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلاً.
وقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
وقوله عليه السّلام: ليس بناكب عن الصراط من سلك طريق الاحتياط.
إلى غير ذلك من الأخبار، وبذلك يظهر أن ما ذهب إليه بعض المتحذلقين من المتأخرين من عدم مشروعية الاحتياط - حيث قال: إن الاحتياط ليس بحكم شرعي فلا يجوز العمل بمقتضاه، بل الواجب إنما يعمل به ما ساق إليه الدليل ورجحه وكل ما ترجح عنده تعين عليه، وعلى مقلده العمل به، والعمل بالاحتياط عمل بما لم يؤد إليه دليل- ناشئ عن الغفلة عما فصلته تلك الأخبار التي قدمناها الدالة على التثليث في الأحكام، ودلت عليه الأخبار الأخيرة وقوله الاحتياط ليس بدليل شرعي على إطلاقه ممنوع كما عرفت مما تلوناه، نعم لو كان ذلك الاحتياط إنما نشأ عن الوساوس الشيطانية والأوهام النفسانية كما يقع من بعض الناس المبتلين بالوساوس فالظاهر من الأخبار تحريمه كما ورد عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من قوله: الوضوء بمد والغسل بصاع، وسيأتي قوم يستقلون ذلك، فأولئك على غير سنتي، والثابت على سنتي معي على حظيرة القدس، ولأنه مع اعتقاد شرعيته تشريع في الدين، والله يهدي من يشاء إلى صراطه المبين.
ولنقطع الكلام حامدين للملك العلام على ما أفاضه من ضروب الإنعام، وأياديه الجسام التي من جملتها الفوز بسعادة الاختتام، مصلين على نبيه وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام، وكان ذلك في اليوم العاشر من شهر ربيع الثاني سنة 1177 السابعة والسبعين بعد المائة والألف.